| الحرب ضد اللغة العربية |
| وما نحن اليوم فيه هو حصاد لما غرس وزرع منذ قرن كامل من الغفلة التقليدية المتوارثة، حتى القرون الأخيرة من تاريخ العرب والمسلمين، فاللغة العربية التي حرّم الاستعمار على السودانيين الجنوبيين استعمالها، العدو اللدود له في كل بلاد إسلامية نكبت به في مشارق الأرض ومغاربها، فهي لغة القرآن لا يمكن للمسلم أن يكون مسلماً إلا إذا قرأ القرآن بلغته، فكانت التوصيات العلنية والسرية، ولا تزال إلى اليوم وإلى الغد القريب في كل مكان مهاجمة اللغة العربية مهاجمة مختلفة الأشكال والألوان، منها السرية ومنها العلنية، ومنها ما ظاهره الإصلاح وباطنه القضاء عليها، وسلخها من ألسنة وقلوب المسلمين بوسائل شتّى، أصبحت اليوم مذاهب وطرقاً مشهورة ومعروفة، استهوت المغفّلين والمنحرفين والسذّج وخريجي مدارس الاستعمار من شباب العرب والمسلمين، وانطلت عليهم فشاركوا في التشكيك فيها وفي عظمتها، حتى يظهروا أمام المستعمرين بأنهم من الجيل الصاعد المثقّف ثقافة عصرية إما شرقية أو غربية، وجبن حماة اللغة العربية عن منازلتهم ومحاربتهم والتظاهر بالكفاح عمّا يدعو إليه المضلّون، فأصبحت الميادين خالية لأولئك المندسّين، يصولون فيها ويجولون، بل إنهم يلقون من الصحافة ومن الشباب الإعجاب والإكبار والتكريم والتقليد. وأسماء هؤلاء الدعاة معروفة لا يجهلها الشباب، وصورهم تحتل صفحات الصحف العربية ومجلاتها في كل مكان، والحديث عنهم هو "موضة" العصرية والتقدم والتجديد، ولا بلاغ إلاّ بالله. |
| ولا يمكن أن تذكر الدعوة الإسلامية، ولا يذكر فيها "الجامع الأزهر"، وجهود علماء مصر فيه وفي غيره من المعاهد عبر قرون متوالية منذ تأسيسه من أكثر من ألف سنة. فشوقي يقول: "ومصر التي تجمع المسلمين كما جمع المسلمون الركن). فقد كان لها الجهاد المشكور في استقطاب الألوف من أبناء الأقطار الإسلامية كلها، يجيئون إليها ويلتحقون بأزهرها، ويعودون إلى بلدانهم بعد ذلك أزهريّين، يقوم على دعواتهم المدّ الإسلامي، وتتثبّت بهم القواعد الدينية التي تكون قد غمرت تلك البلدان قبل مجيئهم، وتتجدّد تيارات الدعوة بهم بين الفينة والأخرى، ويظل الأزهر، وتظل مصر بين منابع الحركات الإسلامية الأخرى المعين الذي لا ينضب، ولجامعي الزيتونة والقيروان في تونس، وللحركة السنوسية في ليبيا، ولجامع القرويين في فاس، وللجوامع الأخرى والمساجد الكبرى في غرب أفريقيا من موريتانيا وكانو وشنقيط و "سكتوا" فضل آخر على الدعوة الإسلامية منذ أكثر من ألف عام، تتجدّد وتمتد وقد تتقلّص وتنكمش، ولكنها مع كل ذلك التمدّد والانكماش كانت المجرى والقناة التي توصل الضياء الديني إلى حيث يسطع وينير. ولا حاجة بنا أن نقول: إن للحرمين الشريفين الشرف الأعظم والفضل الأكبر في أن تكون المنابع المتدفّقة لمساقط تلك القنوات والأنهار. |
| وما دام الحديث عن المدّ الإسلامي وانتشاره في مشارق الأرض ومغاربها، فلعلَّ خاتمة ما نختتم به ما أسهبنا فيه أن أشير إلى أني قد قمت بزيارات للأقلّيات الإسلامية في شرق أوروبا وفي اليونان، فزرتها في بلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا، وزرت المجر متعرّفاً على بواقي الأثر الإسلامي هناك، الذي لم يبق له اليوم إلاّ الأطلال والمعالم، وانحسر عن المجر بالذات بانحسار المدّ العثماني، ولقد حاولت الوصول إلى "بولندا"، إذ توجد بها اليوم أقلية إسلامية منكمشة ومبعثرة في بضع مدن وقرى في الناحية الشمالية الشرقية من العاصمة "فرصوفيا"، لا تزال محافظة على عقيدتها، ملتفّة حول مساجدها، منقطعة عن العالم الإسلامي، مهجورة منه، إلاّ أنها قد بدأت الآن في حركة متواضعة جداً، سمحت بها حكومتها لبناء مركز إسلامي يلتف حوله من تبقّى من المسلمين هناك، الذين كانت لهم في القرون الأخيرة المنصرمة مكانة محترمة في تلك البلاد، وبين سكانها وحكوماتها لما عرفوا به من محبتهم لبولندا وطنهم وتعلّقهم بها والاشتراك في الدفاع عنها من الحركات السابقة التي كانت تجيئها مما حولها، فعرفت لهم البلاد وحكومتها صدق انتمائهم لذلك الوطن واشتراكهم في الدفاع عنه، فكانوا في نظرها جديرين بالاحترام. وقد كانت لبولندا علاقة بالأقطار العربية، وتمثيل فيها، وكان لها ممثل في البلاد السعودية في أول ما دخل الملك عبد العزيز، وكان مسلماً وقائداً من قوّاد الجيش البولندي، قدّم أوراق اعتماده إليه وألقى كلمة مسهبة عن علاقة بولندا ببلاد العرب، وجاءه الرد من الملك عبد العزيز على ذلك بالشكر والتقدير. |
| ولم يتسنّ لي الوصول إلى تلك الأقلية البولندية المسلمة، كما قلت، برغم محاولاتي الكثيرة، ولكنني تخطيتها إلى أقلية إسلامية مغمورة أخرى، تقع في أقصى القطب الشمالي في "فنلندا" وعاصمتها "هلسنكي"، ثم في مدينة "تمبري" الواقعة في الشمال الغربي من العاصمة، وقد أشرت إلى إمام وعالم تلك الأقلية فيما سبق واسمه الحاج حبيب الله. وأذكر كيف وصلت إلى هلسنكي قادماً إليها في باخرة من "استكهولم"، وما كان لي قصد إلاّ زيارة تلك الأقلية والوقوف على أخبارها، وأتذكّر أنه منذ حوالي خمسين عاماً أن أوّل ما سمعنا به عنها كان في مقال نشره يومئذ الكاتب الأديب اللبناني المتمصّر الأستاذ فيلكس فارس في عدد من أعداد مجلة "المقتطف" المصرية، ألقى بذلك المقال أوّل الأضواء على تلك الجالية الإسلامية التي تسكن حوالي القطب الشمالي من "فنلندا" وتعيش فيه، ومن ثم تلفت الناس إلى ما ذكر عنهم، ثم بدأ ذكر تلك الجالية في بعض الصحف الإسلامية والعربية التي تهتم بشؤون المسلمين. |
| والجهل بتلك الأقلية الإسلامية الفنلندية يكاد أن يكون مقتصراً على العرب ومسلمي الهند والشمال الأفريقي، وإلاّ فالصحافة العثمانية كانت زاخرة بأخبارهم تجيء الفينة بعد الأخرى في مناسبات وأحداث تستحقّ أن يذكروا، ثم انقطعت بعد قيام الحكم الكمالي، اللاديني الذي انسلخ عن العالم الإسلامي وكره الانتساب إليه، وكان العرب لا يقرأون تلك الصحف التركية. |
| ولما وصلت إلى "هلسنكي"، ونزلت في الفندق اتّصلت بعاملة الهاتف به، أسألها عن المسجد الذي قد أصبح من معالم المدينة وما يشار إليه في كتب السياحة، وأخذت عنوانه، وكان من المصادفة الجميلة أن كان ذلك اليوم ضحى يوم الجمعة، فتهيّأت مع عائلتي للذهاب لأداء فريضة الجمعة في مسجد تلك الجالية، ووصلنا إلى هناك قبيل أذان الجمعة بنحو ساعتين، ووجدنا المسجد يقع في دور عال من أدوار بناية أقامتها الجالية الإسلامية وقفاً على ذلك المسجد يصرف ريعها على شؤون ذلك الجامع. |
| فأخبرنا أن الصلاة يفتح أبواب المسجد لها في الساعة الواحدة، أمّا الآن فالأبواب مغلقة، لأن المسلمين وإمام المسجد والقائمين عليه كلّهم تجار، ولا يجيئون إلاّ في وقت الصّلاة. |
| وجلست في مقهى يقع بجوار تلك البناية وعلى شارعها، فإذا برجل أفريقي شديد السمرة يجلس بالقرب من المكان الذي اخترته، وطلبنا القهوة، وتفرّس فينا ذلك الرجل ثم قال لي بالإنجليزية: هل تريدون المسجد لأداء الصلاة؟ فقلت له: نعم، فقال: أنا من أفريقيا وقد جئت لهذا الغرض واسترحت في هذا المقهى، أنتظر فتح باب المسجد في الوقت المحدّد للصّلاة. |
| واستأنست بالرجل واستأنس بي، وتحدّثنا عن بلاده، وقال لي: إنني عامل من عمّال إحدى الشركات في "هلسنكي" لها فرع في بلادي، وأنا أجيء كل يوم جمعة إلى هذا المكان لأداء فريضة الصّلاة. |
| وحان وقت الصلاة، ووقت فتح أبواب المسجد في الدور العالي من تلك العمارة، فتحرّكت لأدفع ثمن القهوة لي ولثمن ما طلبه أخونا الأفريقي قبل أن يجيء إلى هذا المكان، فإذا به يغافلني ويدفع حسابه وحسابي قبل أن أفعل، فلما أصررت على أن أدفع ما دفع، قال لي: إِنَّمَا المُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ وأنت ضيفي، فقلت له: لقد صدقت، والأمر كذلك، فهيا بنا إلى المسجد، على شرط أن أدعوك إلى طعام الغداء، فلما بدا عليه الاعتذار بحياء موروث، قلت له بدوري: إِنَّمَا المُؤمِنُونَ إِخوَةٌ، فابتسم وهو يقول لي: وهو كذلك! |
| ركبنا المصعد الذي انتهى بنا إلى الدور الخامس أو السادس، وكان دليلي أخونا الأفريقي، فإذا بجناحين واسعين ينفتح أحدهما على الآخر في شبه فصل ملاحظ، كان الجناح الأمامي للرجال والجناح المتفرّع عنه في الخلف للنساء، ووجدت أن أغطية بيضاء ناصعة البياض قد مدّت على السجاد في قاعتي المسجد عرفت أنها للمصلّين تطوى بعد كل صلاة وترسل للغسيل والكي لتفرش عند كل صلاة مرّة أخرى جديدة طاهرة ناصعة البياض تسرّ الناظرين. |
| وكنّا قد خلعنا أحذيتنا عند الباب ووضعناها في أكياس من النايلون الرقيق الأبيض، وأدخلناها في رفوف منسّقة جميلة على كل موضع حذاء رقم واضح، لا يكلف صاحب الحذاء إلاّ أن يحفظه ليعود إليه بعد الصلاة بين من يعودون في صفوف هادئة متراصّة، يأخذ الكيس ويفرغ منه حذاءه ثم يلبسه بعد ذلك ويطوي الكيس مرة أخرى ويلقيه في ذلك الرفّ. |
| وأَدّيت تحية المسجد، ثم ما لبثنا أن رأينا المؤذن يقف بجوار المنبر المتواضع المجاور للقبلة، ثم يرفع عقيرته بصوت لا يزيد على حاجة السامعين في الجناحين، وكأنه يقرأ الأذان قراءة مجوّدة، وكان في خشوع مؤثر ما لبث بعد مدة أن ارتقى درجتي المنبر وبدأ يلقي خطبة الجمعة في مثل هدوء ورصانة أدائه للأذان، وقد حمل في يمينه عصا طويلة أشبه شيء بالرمح إلاّ أنها بلا سنان، يتوكّأ بها، وكانت الخطبة طبعاً باللغة التركية، ليست التركية المعروفة في إسطنبول ولكنها تركية جبال "الأورال" التي جاءت هذه الجالية منها وجاءت معها بلغتها. |
| وتتخلّل خطبة الجمعة الوافية والمختصرة ما سنّ في أن تحتوي الخطب عليه من بعض الأحاديث وبعض الآيات، وجلس بعد ذلك على المنبر نحو دقيقة يفصل بها بين الخطبتين، ثم قام ليبدأ الخطبة الثانية على نسق خطبته الأولى، حتى إذا ما انتهى بـ إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى القُربَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحشَآءِ وَالمُنكَرِ... إلى آخر الآية، وقف مقيماً الصلاة ورفع صوته خفيضاً ودوداً بإقامتها، وكان قد تجمّع في جناحي المسجد نحو ثلاثين رجلاً، ومثلهم أو أكثر منهم قليلاً من السيّدات، ووقف الجميع خلف الإمام وصلّى الركعتين بسورتين قصيرتين، أنهاهما بالسلام، والمصلون –كما قلنا– صفوف خلفه على تلك الأغطية البيضاء الناصعة يأتّمون به. |
| وبدأت الأذكار بعد ذلك، والشعب التركي ومن ينتمي إليه من الشعوب المجاورة له في أوروبا وجنوب آسيا من أشدّ الناس ورعاً وأطولهم تسبيحاً وتحميداً بعد أداء المكتوبات، وأكثرهم تطويلاً لهذه السنة التي قد يتضايق بطولها البعض من غيرهم. |
| وقام الناس فأدّوا المسنونة، ثم أقبل بعضهم على بعض مسلمين متصافحين، متوادّين، وقد غطّى كل واحد من الرجال رأسه إما بمنديل أو بكوفية يجدها أمامه في المسجد، تتّخذ لمثل هذه الظاهرة التي يحرص الأتراك عليها حرصاً شديداً، ويتجنّبون أن يؤدّوا الصلاة مكشوفي الرؤوس. |
| وفاتني أن أقول إن على تلك الأبسطة البيضاء قد نثرت عشرات من المسابح البسيطة جداً، والمؤلّفة من نوى التمر لمن يريد أن يستعين بها على التهليل والتسبيح بعد الصلاة، وكلهم قد فعل ذلك – وكنت قد صحبت من المدينة المنوّرة في تلك الرحلة التي قصدت بها زيارة تلك الجاليات في شرق أوروبا، حتى شمالها في فنلندا، مجموعة من المسابح الشعبية التي تباع عند أبواب الحرم النبوي، حملتها هدية لمن سأجتمع بهم، لأنها ستكون موضع قبولهم وغبطتهم، خصوصاً إذا علموا أنها من المدينة المنوّرة، كما يفرحون بسجاجيد الصلاة وإذا علموا أنها كذلك، والتي حملت منها عدداً آخر لتلك الغاية. |
| ومع الأسف الشديد إن المسلمين عبر السنين الطويلة يشترون هذه الأشياء من الحرمين الشريفين غير عالمين بأنها مستوردة ومصنوعة في خارج العالم الإسلامي وفي معامل إيطاليا بالذات، ولكنهم يفرحون بها فقد لامست الأراضي النبوية، فقدمت منها عدداً بعد الصلاة إلى الإمام عندما قمت وسلّمت عليه وعلى من حوله وعرّفتهم بنفسي، فأخذوا تلك السبح ومعها سجادة أو سجادتان، وتجمّعوا حينئذ حولي يسألونني عن الفندق الذي نزلت فيه ومتى يمكن أن يزوروني ليدعوني بعد ذلك إلى طعام الغداء في بيت أحد كبارهم، ثم أبى الإمام بعد ذلك إلاّ أن يوصلني إلى الفندق، فصحبت معنا أخانا الأفريقي لتناول طعام الغداء معنا، حيث نزلت. وهكذا كان يومنا الأول في زيارة إخواننا في مدينة هلسنكي. |
| وسأذكر بعض الشيء عن تلك الجالية قبل أن تجيب هذه الدعوة، هؤلاء يسمّون هناك بالأتراك، وأصولهم في الغالب من القبائل والأجناس التركية في جبال "الأورال" وما حولها. وكان أجدادهم المهاجرون من الموجات التي عبرت البحر الأسود وشبه جزيرة القرم من تلك النواحي إلى شرق أوروبا الشمالي. |
| ثم ما لبثت جماعات متفرّقة منهم تشتغل بالتجارة أن اتّجهت نحو الشمال عبر ما كان يسمّى بدول البلطيق من "لتوانيا" و "استونيا" و "لتفيا"، حتى قذفت بهم أمواج الهجرة إلى عاصمة فنلندا هلسنكي، فاستقرّت تلك الجالية الصغيرة بها منذ عشرات السنين، واحتفظت بإسلامها وبعاداتها الشرقية الإسلامية، واتّخذت لنفسها من أنواع التجارة ما اشتهر يومئذ ولا يزال من "الفراء" جمع "فرو"، وهي جلود الثعالب والدببة والحيوانات الأخرى التي تتّخذ جلودها بعد صيدها في تلك الأصقاع تجارة نفيسة ثمينة في جميع أنحاء روسيا وما جاورها في الشمال، يتّخذون منها أغطية الرؤوس والمعاطف للرجال والنساء، وتكاد تلك التجارة في فنلندا أن لا تخرج إلاّ نادراً عن التجار المسلمين. أتذكّر كبيرهم يومئذ عثمان علي، وهو شيخ تجار هذا الصنف من التجارية، والسيد حيدر علي وهو خطيب وإمام المسجد والمشرف على شؤونه، والسيد عبد الله علي وكان في ذلك الوقت في شبابه وحيويتّه كما كان الآخرون في وقارهما ومظاهر لطفهما. |
| وبقيت تلك الجالية عشرات السنين المتوالية متعاقبة على ما كانت عليه، وبقيت على صلة قويّة مع الجمهورية التركية بعد صلاتها بالخلافة العثمانية، بحيث يتولّى مندوب تركي ملحق بالسفارة التركية في هلسنكي شؤونهم، يرجعون إليه في مشاكلهم وفي طلب معلمين من تركيا لمدرسة أقاموها لأبنائهم وبناتهم، وكانوا قد أتّخذوا مقبرة مستقلّة بهم، تغطي كل قبر فيها شاهدة فيها اسم الميت تحت "بسم الله الرحمن الرحيم"، الذي يجيء الهلال الأحمر ذو النجمة وهو شعار الخلافة حافّاً بها من جانبها أو تحتها، وهم فخورون بمقبرتهم وبمسجدهم وبمدرسة أبنائهم وبناتهم، ونساؤهم وبناتهم مشهورات بالاحتشام الكامل، يحافظون على لغتهم وعلى قراءة القرآن لأبنائهم وأحفادهم، وعلى معرفة أركان سنن الصلوات الخمس. |
| قالت إحداهن لزوجتي وقد لفت نظرنا أن بناتها الثلاث يتكلّمن اللغة التركية مع أمّهن وأبيهن ومن حولهن وهنّ صغار السن بعد أن سألتها زوجتي: ما هي وسيلة نجاحكم في الإبقاء على لغتكم في أفواه أبنائكم وأطفالكم بدون أن تتأثر باللغة الفنلندية أو غيرها؟ فضحكت السيدة وقالت: اهتدينا بعد عناء طويل وضياع للغتنا على ألسنة أبنائنا، إلى أن خير وسيلة للحفاظ على لغتنا وقوميّتنا أنه إذا جاء أحدنا مولود أو مولودة وشارف العام الأوّل من عمره أخرجنا الخادمة العاملة في البيت، وهي فنلندية، لئلاً يسمع الأطفال إلاّ لغتهم، إلى إن تتمكّن اللغة من ألسنتهم وعاداتنا من طباعهم، حتى إذا كبروا وشبوا وتجاوزوا سن الطفولة أصبح تعلم اللغة الفنلندية في المدرسة وفسحاتها ومع الأطفال من الجيران، فتكون الفنلندية هي اللغة الثانية لهم، ولا كلام لنا معهم إلاّ بلغتنا، فيكبرون على ما عوّدناهم عليه، برغم أننا كنّا نقول إننا نقبل ذلك برضى كامل، ولا نرضى أن نضيع في هذا المحيط الأجنبي، ويجيء نشؤنا وأجيالنا منسلخين عن مقوّمات أصلهم والمحافظة على لغتهم، برغم أننا مواطنون فنلنديون، فقد اعترفت الحكومة الفنلندية بالدين الإسلامي، بل كانت من أوائل الدول الأوروبية الشمالية، إذا لم نقل أنها أوّلها، فسمحت لهم بالمدارس وأعانتهم حسب القانون الفنلندي بمصاريف المعلمين المسلمين الذي يؤدّون واجب تعليم الدين واللغة التركية لأبناء تلك الجالية، فجمعوا بين الحسنيين ونالوا إعجاب كل من رآهم. |
| عدد المسلمين يوم زرتهم منذ بضعة عشر عاماً كان يتراوح بين الألف والألف وخمسمائة مواطن فنلندي من أصل تركي، كانوا ولا يزالون موضع احترام الحكومة الفنلندية، ويتعصّبون لها ويعتزّون بها وطناً لهم، ولكنهم يبقون كما قالوا لي مسلمين فنلنديين، مع من أسلم من أفراد آخرين من أصول إسكندنافية، ولا يزوّجون بناتهم إلاّ للمسلمين، وهم على ذلك الحال سعداء بتجارتهم وحياتهم الإجتماعية التي لم تكن منعزلة، ولكنها مشاركة في الحركات الوطنية والاجتماعية، إلاّ أن الإسلام عندهم فوق كل شيء وحكومتهم الفنلندية تحتفظ لهم بالاحترام على هذا الأساس، وتؤدّي لهم الواجب نحو المواطن الفنلندي الذي يقومون بمثله هم باعتبارهم مواطنين. |
| حجّ منهم عدد منذ بضعة عشر عاماً، وكانت لهم صلات ببعض إخواننا المهاجرين إلى الحرمين من أبناء جنسهم وقبائلهم، وقد زرت بعضهم بعد عودتي من فنلندا في مكة المكرمة بشارع المنصور، ولقب الحاج بينهم لمن شرّفه الله بحمل هذا اللقب شيء مقدّس. |
| وأعلق على ما ذكرت وما رأيت وما سمعت من زيارتي لتلك الجالية في "هلسنكي"، وما ذكرت وعلمت وسمعت من تعصّبهم للغتهم وأخراجهم الخادمات الفنلنديات من بيوت كل من حملت سيدة البيت بطفل من أطفالها وفور ولادته حتى لا يسمع في السنوات الخمس من طفولته إلاّ لغة آبائه وأجداده وهي التترية التي يسمّونها تركية. |
| وتذكرت حالنا معشر العرب حوالي الخليج، كيف نستقبل المربيات الأجنبيات من الأقطار الآسيوية ونسلم إليهن أطفالنا وفتياتنا، ونشتغل عنهم بشؤون حياتنا الوافدة علينا من الزيارات و"الكوافيرات" و"المعارض" و "السوبرماركت" والسهرات والزيارات التي تشغل أوقات الطبقات الراقية والمتوسّطة من القادرين على استقدام الشغالات، فينشأ أطفالنا مضطربين، فيما يسمعون من أمّهاتهم ومربياتهم العجميات، وبدلاً من أن تتعلّم المربيات العربية يتعلّم أطفالنا لغاتهن العجيبة، وينطبعون بطباعهن ويرون منهم ما يستحسنونه من عادات بلادهن وحركاتهن وسكناتهن، فتتمخّض من كل ذلك أزدواجية مشوّشة مضطربة يشبّ عليها الجيل الذي قدر له أن تكتنفه تلك الأجواء في بيوت أهله. وقد كتب الكاتبون وحذر المحذّرون من مغبة ما أصبحنا اليوم نجابهه رضينا أم أبينا، ولكن الناس قد ألهتهم تجارتهم وأموالهم وعصريّتهم التي سلبت ألبابهم وطّورت حياتهم وأبعدتهم عمّا ألفوه قبل سنوات، ولم يفكّروا فيما فكّرت فيه تلك الجالية الإسلامية في فنلندا، ولم يتحمّلوا مشاق التوجيه والتربية والتنشئة لأجيالهم. |
| وكم من الأمثلة التي يمكن أن تضرب في مثل هذا المضمار، فيما حولنا، لا نجد الشجاعة ولا الإخلاص ولا التحمّل في أن نضطلع بها ونلتزم بمبادئها، ونكون مسؤولين أمام الله ثم أمام التاريخ عن عزّتنا وكرامتنا وشخصيّتنا. |
| أصبحت الأجيال العربية متدرّجة الآن شيئاً فشيئاً نحو الانسلاخ عن معالمها، وما هي إلاّ سنوات متوالية حتى نصبح بدون لون أو طعم أو ريح، معلّقين بأذيال الشعوب الأجنبية المتقدمة التي بهرنا تقدّمها، فعشقناها والتزمنا بأن نحذو حذوها سواء أكان ذلك عن تصميم أم عن إهمال لواجباتنا البيتية والأسرية، وستنتشر هذه الأمراض بمرور السنين المقبلة إذا لم نوقف كل شيء عند حدّه، حتى لا ينقلب إلى ضدّه. والمسؤول عن كل ذلك هو ربّ البيت وربة البيت وليس للدولة إلاّ الإرشاد والموعظة الحسنة، وهو شيء ملاحظ ومسموع إلاّ أن الأسماع والأبصار بعيدة عن مراميه. |
| كان من أوائل مواطنينا السعوديين الذين زاروا وتعرّفوا على هذه الجالية الإسلامية في فنلدنا أخونا الصديق سعيد عبيد بن زقر (رحمه الله)، التاجر المعروف في جدّة، ووالد السيد وهيب وجدّ حفيده عبيد بن وهيب بن زقر. |
| وكان قد وصل إلى فنلندا منذ حوالي أربعين أو خمسين عاماً، تاجراً يبحث عن وكالات وأعمال تجارية، وفرحت تلك الجالية به يومئذ في تلك البلاد، وعرفته حكومتها فأسندت إليه بعد ذلك لقب وعمل قنصل فنلندا في جدّة، وكنّا نستقبله في القصر الملكي يوم كنت في الديوان ومسؤولاً في بعض السنين عن التشريفات بين ممثلي الدول الأوروبية وغيرها في جدّة، فتجيء لمقابلة الملك عبد العزيز ثم الملك سعود بينهم باسم قنصل فنلندا الفخري، وإن كان لابساً في تلك الأيام وكانت أيام شبابه الثوب و"الكوت"، ثم رداء نسميه الإحرام ملفوفاً على رأسه على هيئة عمامة حجازية من "الغبان" الفاخر، ثم تطوّر هذا القنصل الصديق فلبس العباءة وأبقى العمامة تعصّباً لها، حتى رأى أن موجة العقال والغتر قد أصبحت الزي الرسمي للبلاد ووجهائها وتجارها فجذبته عروبته إلى الالتزام بها. |
| وأذكر أن بين السعوديين الذين زاروا فنلندا وكنت أحسب أنني السعودي الثاني بعد أخينا "أبي وهيب" بن زقر، فلما رجعت عالي الرأس بهذا السبق ولقيت زميلي صفي، في مدرسة الفلاح، المتخرجين منها معي والمتزاحمين معي على مقاعد فصولها: معالي السيد أحمد شطا رحمه الله ومعالي الدكتور حامد هرساني حفظه الله، قالا لي: نحن قد سبقناك ببضع سنوات إلى فنلدنا، غير أننا لم نقم إلاّ أياماً معدودة، وأنت فقتنا بالإقامة الطويلة والاختلاط بالجالية الإسلامية، فنحن شركاؤك في هذا المضمار، أذكر هذا للتاريخ. |
| وقال لي الصديق الهرساني مداعباً كعادته معي: بأنني أتفوّق عليك بأني قد أصبحت مطوّفاً لتلك الجالية الفنلندية، لا ينزلون إلاّ عندي عندما قدمت طلائعهم للحج منذ سنوات، فأنت قد صرفت الشيء الكثير في زيارتهم، وأنا قد ربحت مثلَيْ ذلك من تطويفهم، ولا تزال صلتي بهم على هذا الأساس مستمرة أحافظ عليها كما تعرف زمالتي وأخوتي لك. |
|
|
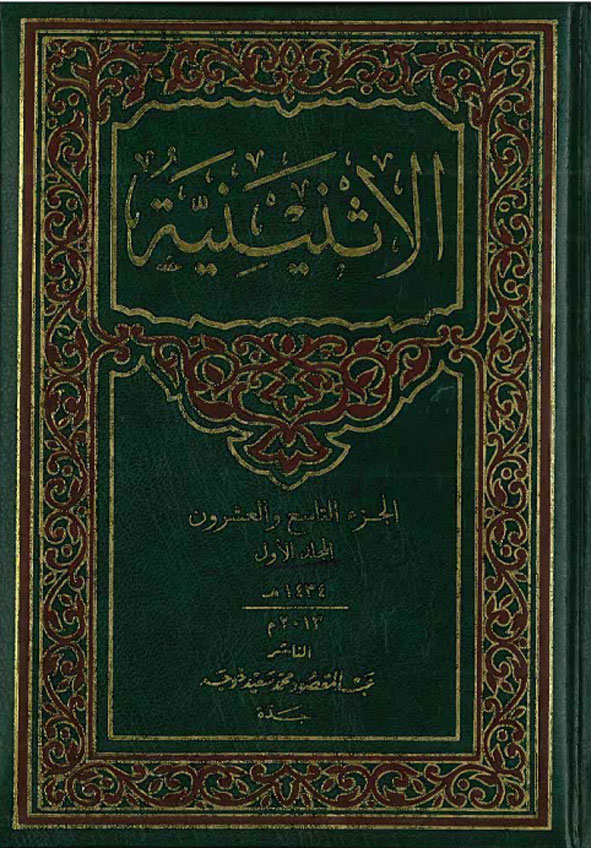
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




